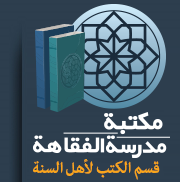
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال

- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 105 | ||||
|
الناس تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا)[1] ثم حرر معناه عند المالكية، ومواضع الخلاف بينهم فيه، فقال: (حرر موضع الخلاف فقال: اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لا، والأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى الأمران وهو المسمى ب (الذرائع) عندنا: فالأول لا بد من مراعاته، والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه، ومنهم من لا يراعيه، وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة)[2] ولأجل مبالغة مالك في سد الذرائع كرّه بعض المندوبات لئلا يعتقد في وجوبها أو سننها، وذلك شأنه في كراهة كُلّ النَّوافل التي تتخذ على طريقة الورد في أيام معلومات، ومن ذلك أنَّه كره صيام السِّتة أيام من شهر شوال، لئلا يعتقد العامّة أنَّها كصيام رمضان واجبة[3]، وأوَّل الحديث: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)[4]، على أنَّ المقصود بشوال طول السَّـنة أي ما يقابل رمضان، فاستحب صيام النَّافلة دون تحديد يوم أو أيّام معيّنة من السَّـنة، قال مالك في الموطأ: (ما رأيت أحداً من [1] نقلا عن: البحر المحيط في أصول الفقه، ج8، ص 90. [2] المرجع السابق، ج8، ص 90. [3] يقول الشاطبي في الاعتصام مبررا رأي مالك في هذه المسألة: (فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه، لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل؛ لئلا يكون ذريعة لما قال، كما فعل الصحابة في الأضحية، وعثمان في الإتمام في السفر) (الاعتصام، ج2، ص 492) [4] صحيح مسلم، 2، ص 822. |
||||
| اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 105 | ||||
|
www.eShia.ir