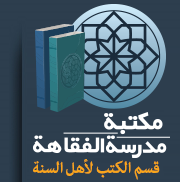
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال

- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : المفتاح في الصرف المؤلف : الجرجاني، عبد القاهر الجزء : 1 صفحة : 73 | ||||
|
الأمر: قُلْ، قُولاَ، قولُوا، قُولِي قُولاَ قُلْنَ، استوى جمع المؤنث في الماضي والأمر، أصله: اُقْوُلْ، بضمّ الواو، نقلت حركتها إلى ما قبلها، وحذفت الواو لالتقاءِ الساكنين، ثم حذفت الهمزة لانعدام الاحتياج إِليها. وتسقط العين، واواً كانت أو ياءً، حيث تُسَكَّنُ اللام [26] لالتقاءِ [27] الساكنين في الأمر والنهي والجحد وغيرها. اسم الفاعل: قَائِل قَائِلاَنِ قَائِلُونَ، إِلى آخر الوجوه، أصله: قَاوِل، قلبت الواو همزة تخفيفاً، فصار "قائل " [28] ، ولم تقلب في "عَاوِر" [29] كما في "عَوِرَ"، لأنه بمعنى "اعْوَرَّ" لسكون ما قبلها. اسم المفعول: مَقُول، مَقُولاَنِ، مَقُولُونَ، إِلى آخر الوجوه، أصله: مَقْوُول، نقلت الضمة من العين إِلى ما قبلها، فالتقى الواو الساكنان، [و] حذف آخر الساكنين وقيل [30] أوّله، فصار مَقُولاً، فالوزن على حذف آخره (31) [26] بعدها في الأصل: "لا"، وهي زائدة لا لزوم لها. [27] في الأصل "لالالتقاء". [28] تحتها بخط فارسي أدقّ حاشية، وهي: "وإنما يكتب الياء لمجاورة كسرة الهمزة". [29] في الأصل "عاول " باللام، ولم أجدها. وإنما "عاوِر" واعْوَرَّ، وعَوِرَ، صحّت العين (الواو) لصحتها في أصله، وهو "اعْوَرَ" لسكون ما قبلها. (اللسان / عور) . وذكر ابن عصفور أنه "إن صحّ حرف العلة في الفعل صحّ في اسم الفاعل، نحو "عاوِر"، المأخوذ من عَوِرَ،. . . " (الممتع 1 / 328) . وذكر الميداني منها: عاوِر وصايِد - غير مهموز - (نزهة الطرف 43) . [30] في الأصل "فقيل " بالفاء. (31) تحتها في الحاشية بخط فارسي مخالف الواو الزائدة. |
||||
| اسم الکتاب : المفتاح في الصرف المؤلف : الجرجاني، عبد القاهر الجزء : 1 صفحة : 73 | ||||
|
www.eShia.ir