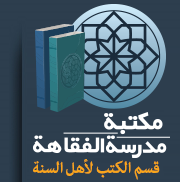
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال

- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 129 | ||||
|
وذكر مقاصد الوضوء، فقال:﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[1] وذكر مقاصد القصاص، فقال:: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[2] وذكر مقاصد حد السرقة، فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[3] وهكذا وضحت السنة المطهرة مقاصد الشريعة الإسلامية، كما قال الشاطبي: (وإذا نظرنا إلى السنّة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور فالكتاب أتى بها أصولاً يرجع إليها، والسنّة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيه منها فلا تجد في السنّة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في السنّة)[4] المنهج الثاني: وهو يعتمد على ما يتصوره أو يتوهمه من المصالح، ثم يحاول أن يفسر الشريعة على أساسها، فيقدم المصلحة المتوهمة على النص القطعي. بل إن بعض الفقهاء تصوروا أن لهم مطلق الحرية في ابتداع الوسائل التي تحقق المقاصد التي يرون شرعيتها، حتى لو خالفت الظاهر من النصوص. [1] سورة المائدة: 6. [2] سورة البقرة: 179. [3] سورة المائدة: 38. [4] الموافقات، ج4، ص 346. |
||||
| اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 129 | ||||
|
www.eShia.ir